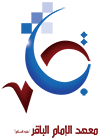إن موقع الإمام الحسين عليه السلام في الإسلام، وفي قلوب المسلمين، أظهر من أن
يخفى، وأوضح من أن تناله يد الظلام بعتمة، فقد تواترت الأحاديث الشريفة عن النبي
الأعظم (ص)، في بيان فضله، ومكانته في الإسلام، ومدى أهميته في بقاء هذا الدين، من
خلال موقع الإمامة من جهة، ومن موقع استشهاده وقتله من جهة أخرى، وسواء على المستوى
الدنيوي أو الأخروي.
إلا أن الأمر المهم، والمثير للتساؤل، والذي سنحاول تسليط الضوء عليه في المقام، هو
تأثير قتله عليه السلام في نفوس الناس، المؤمنين منهم على وجه الخصوص ولماذا أعطي
هذه الأهمية الكبرى، من دون سائر الناس، في الوقت الذي نرى فيه الكثير من حالات
القتل والجريمة، والتي ربما يجد الكثيرون فيها أشد فظاعة، وتنكيلا، وإجراما، من
الناحية الشكلية والظاهرية، وربما بشكل يومي أو شبه يومي، من قتله عليه السلام
وأصحابه، فهل يبقى من المنطقي والمقبول أن تولى قضية استشهاده وقتله، هذه الأهمية
والعناية من دون سائر القضايا، مع ان الجريمة هي الجريمة، والقتل هو القتل.
ولماذا حرص النبي الأعظم (ص) على ابراز جريمة قتله عليه السلام بهذه الدرجة،
والاهتمام بها اهتماما عاليا، حتى غطت في ميزانه (ص) على سائر ما عداها من الجرائم.
إن من الظاهر لكل أحد أن النبي (ص) لا يتحرك بحركة، ولا ينطق بكلمة، انطلاقا من
خلفية عصبية، أو قبلية، أو عائلية، أو نحو ذلك، وإنما ينطلق، قبل كل شيء، من خلفية
عقائدية، هدفها الحفاظ على المبدأ والدين، كيف، وهو الذي (وما ينطق عن الهوى إن هو
إلا وحي يوحى[1])، وهو القائل في ما روي عنه للسيدة الزهراء عليها السلام (يا فاطمة
اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا).
بناء عليه، لا بد من ملاحظة كلامه (ص) و السعي لفهم مدلولاته بدقة متناهية، وقراءة
كل مفردة وكلمة من مفرداته وكلماته، في كل حديث من احاديثه الشريفة، من خلال موقعها
في الجملة، ودراسة دلالاتها الافرادية والتركيبية، والتأمل في مضامين الكلام، في
محاولة استكشاف الغايات التي يهدف بيانها وإثارتها، وتوجيه الأنظار نحوها، في أي
موضوع وباب نطق به رسول الله (ص)، وأراد إيصاله إلى الناس.
وفيما يرتبط بقتل الإمام الحسين عليه السلام، فقد ورد في الحديث الشريف عنه (ص) أنه
قال: (إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا).
إنه رغم شهرة هذا الحديث الشريف، وكثرة تداوله على الألسن، وفهم مضمونه على نحو
الإجمال من سائر الناس، إلا أنه يحتاج إلى توضيح مفرداته، ومدى ما لها من الدلالة،
ليتبين مدى أهميته، وأهمية الأبعاد الفكرية والإنسانية، التي ينطوي عليها، وانطلاقا
من المقدمة التي ذكرناها لجهة التعامل مع أحاديثه أو وصاياه، وأوامره، ونواهيه (ص)،
فنقول:
أولا: الحرارة والبرودة:
إن معنى الحرارة والبرودة واضح من الناحية اللغوية، إلا أنهما ينطويان
على معان أخرى ملازمة لهما، ينبغي أخذها بعين الاعتبار، لعدم إمكان انسلاخها عنها
من الناحية الواقعية والتكوينية، فإن الحرارة ملازمة للحركة، والبرودة تستلزم
السكون والثبات.
ولهذا فإن من مفردات الحرارة ومصاديقها الحرية، فعندما يقال زيد حر، يعني أنه متحرك
كما يشاء، لا تقيده أية أغلال، ولا تعيقه أية حواجز، ويتمتع بالقدرة على الانطلاق
والتحرك بالوجهة التي يرتضيها ويريدها.
ومعنى ذلك أن الحرارة المذكورة في الحديث الشريف، ليست مجرد هيجان عاطفي، يمكن
إفراغه وتهدئته بمجرد إبراز الحزن والألم، أو سكب بعض الدموع، أو التأسف، والإحساس
بالألم تجاه المصاب المفترض، بل هي حرارة هادفة تستدعي حركة معينة تتوافق، أو
تتطابق مع الحالة المعينة، أو الظاهرة المفترضة للحركة.
وما دامت الحرارة مستلزمة للحركة، والبرودة مستلزمة للسكون والثبات، فمعنى عبارة لن
تبرد أبدا هو أن المتأثرين، أو المتفاعلين مع قضية قتل الحسين عليه السلام سيظلون
في حركة دائمة، وانطلاق ثابت باتجاه الهدف، الذي رسمه الحسين عليه السلام بقتله،
وأراد للناس أن يعيشوه، ويتفاعلوا معه بشكل دائم وحيوي وأن هذه الحركة الدائمة لا
يمكن أن تسكن أو تثبت، نتيجة برود يصيبها، مهما تقادم الزمن، وتتالت الأجيال،
وتوالت العصور.
ثانيا: القلوب:
القلب كما يستفاد من معاجم اللغة، ومن موارد استعماله في القرآن الكريم،
يعني الحركة والتحول من جانب إلى جانب، قال تعالى:
﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات
الشمال[2]﴾، وقال تعالى:
﴿يقلب الله الليل والنهار[3]﴾، وقال تعالى:
﴿فانقلبوا
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء[4]﴾.
قال أحمد بن فارس: (قلب... أصلان صحيحان أحدهما يدل على خالص الشيء وشريفه، والآخر
على رد شيء من جهة إلى جهة[5]).
وعلى هذا الأساس يطلق القلب على العضلة الصنوبرية في الصدر من الكائن الحي، من جهة
أنه أشرف شيء فيه، وبه تثبت حياته ووجوده المادي.
ولكن الظاهر أن استعماله في خالص الشيء وشريفه، أعني العضلة المخصوصة، من باب
التطبيق على أشرف المصاديق وأهمها، لأن القلب هو مصدر التغير والحياة في الحيوان،
فهو مضخة الدم ومنظمة حركة البدن، التي بواسطتها تستمر الحياة، هذا في المعنى
المادي.
إلا أن له إطلاقا أعلى وأسمى منه، يتعلق بعالم المعنى والروح، ومنه قوله تعالى:
﴿إن
في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد[6]﴾.
وقوله تعالى:
﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم[7]﴾.
وقوله تعالى:
﴿نزل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين[8]﴾.
وقوله تعالى:
﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب[9]﴾.
والمراد بالقلب في هذه الآيات الشريفة، العقل الواعي، المتفاعل مع الوجدان
والعاطفة، حيث رتب الإنذار في الآية الأخيرة على كون القرآن الكريم في قلبه الشريف
(ص)، كما أن الآية الثانية دلت على أن محور الثواب والعقاب على سلامة القلب، فهو
ميزان قبول الأعمال، فيما إذا ترتبت عليه.
وأما الآية الشريفة الأولى فتدل على أن فائدة التذكير إنما تتم عند من يمتلك قلبا،
وأما من لا تنفعه كل هذه المواعظ فهو بمثابة من ليس له قلب أصلا، بقرينة الكثير من
الآيات الشريفة، كقوله تعالى:
﴿لهم قلوب لا يفقهون بها[10]﴾.
وقوله تعالى:
﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها[11]﴾.
والنتيجة أن القلب عبارة عن العقل الواعي، المنفعل بالعاطفة والوجدان، بحيث يحرك
الإنسان ويدفعه نحو جادة الصواب والحق، ولهذا عبر في حالة الانحراف عن جادة الصواب
بأن (على قلوب اقفالها) وعبر في آية أخرى بالزيغان، كما قال تعالى:
﴿فلما زاغوا
أزاع الله قلوبهم[12]﴾.
ولازم ما تقدم أن كل إنسان يتمتع بوجود خاصية القلب في داخله، ناشئة معه منذ بداية
تكوينه، فهو مجبول بفطرته، ولازم لإنسانيته، وهو الذي يسيرها بالوجهة الصحيحة
وينميها، أو يسيرها بالاتجاه الخاطئ فيكبتها ويميتها، يكون اطلاق القلب عليها من
باب التجوز وملاحظة المنشأ، نتيجة سوء تعامله معها، ولذلك يصح وصفها بالعمياء، كما
في قوله تعالى: (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور[13])، حيث
إن خصوصية العمى، التي هي عدم الرؤية، ناشئة من الظلمة المحيطة بالمرء، سواء نتيجة
خلل في آلة البصر وهي عينه الظاهرة، أو انتشار الظلام، وعدم وجود الضوء، الذي يشكل
الشرط الثاني للإبصار، وعليه فعدم رؤية الأمور المعنوية، الناشئة من الظلمة
الداخلية، المحيطة بالقلب والعقل، وعدم ربطها بالحقيقة ربطا صحيحا، أولى بالوصف
بالعمى، إذ البصر وآلته التي هي العين، ليست أكثر من وسيلة وآلة تكشف للعقل، عما
يحويه النور المفترض في ما وراء المادة، وهو الأصل في الهداية إلى حقائق الكون
والحياة.
وإلا فإن حاسة البصر مما يتساوى فيه الإنسان وغيره من الحيوانات، بل إن بعض
الحيوانات يتمتع بحاسة بصر اقوى مما يتمتع به الإنسان بمراتب، كالنسر مثلا، ومع ذلك
فهي لا تؤهله لإدراك الحقائق، إلا بمقدار ما يؤمن له رزقه وطعامه، على نحو غرائزي،
ولا يصح وصفه بالقوة العاقلة، أو بوجود القلب لديه.
ثالثا: المؤمنون:
الإيمان إفعال من الأمن، والأمن هو الاطمئنان والسكون، بمعنى أن النفس
تركن وتطمئن، فلا يبقى فيها أي توتر أو خوف.
فالإيمان فعل الأمن، وتحصيله بالوعي والاختيار، فالفرق بين (أمن) و(آمن)، أن الأول
يحصل للإنسان من دون فعله، أو بفعله لكن من دون قصد وإرادة، بل قد يحصل على الأمن
نتيجة عوامل وظروف خارجية أو تكوينية، ليس له أي يد فيها.
وأما الثاني فهو فعل قصدي واختيار واع، ينتج عن تبصر وإدراك للعوامل والمؤثرات،
التي ينبغي أن يستفيد منها في تحصيل الأمن، وقد اتفق علماء اللغة على أنه يتضمن
معنى التصديق، والتصديق لا يكون إلا عن إدراك واع، ولهذا يتعدى في هذه الحالة
بالباء، فيقال آمن بالله، بمعنى أنه استند إلى الله تعالى في تحقيقه للأمن
والاستقرار.
وتارة أخرى يتعدى باللام، للدلالة على تنزيل موضوع الإيمان منزلة الواقع، سواء كان
محلا لهذا الإيمان، أم لم يكن محلا له، كما في قوله تعالى: (يؤمن بالله ويؤمن
للمؤمنين[14])، حيث أن المؤمنين في معرض تحصيل الأمن بالنسبة إليه، إلا أن ذلك ليس
على نحو الاستقلال عنه تعالى، لأن إيمانه لهم قد يصيب الواقع،من جهة ارتباطهم بالله
تعالى، وقد لا يصيبه، من جهة إمكان أن يخطئوا الهدف المنشود، نتيجة خلل عملاني أو
نفسي عندهم، وإن كانت الآية الشريفة تتضمن بعدا تربويا وأخلاقيا، لسنا في معرض
الحديث عنه فعلا.
إلا أن فعل الأمن هذا، تارة يصيب الواقع والحقيقة، كمن آمن بالله تعالى، فإن من لجأ
إليه فقد لجأ إلى ركن وثيق، بل كيف يخاف شيئا من كان الله تعالى نصيره.
وتارة أخرى لا يصيب الحقيقة والواقع، فإن الكثير من الناس يتوهم أن أمنه مرتبط
بالمال، أو الرجال، أو المنصب، أو السلاح والعتاد، أو نحو ذلك، فيسعى جهده لتحصيل
ذلك، بحثا عن الأمن المنشود، ولكنه بعد حين يكتشف أن كل ذلك لا يشعره بالأمن
والاستقرار، إن لم يزد من توتره وخوفه، وهو ما نراه بشكل واضح لدى الزعماء
والأغنياء على العموم.
ومن هذا الباب اللجوء إلى الأصنام والأوثان، كذلك أتباع الأهواء والشهوات، وغير ذلك
من الأقوياء والسلاطين، فإن كل ذلك يبعد المرء عن تحصيل الأمن والأمان الواقعي، وإن
زعم التابعون ذلك، ولهذا أوصى الله تعالى قائلا:
﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون[15]﴾.
فإن سلوك أي طريق مخالف أو مواز لصراط الله المستقيم الذي وصى عباده باتباعه
وسلوكه، لن يوصل إلى الغاية المنشودة.
رابعا: القتل:
القتل عبارة عن الإماتة وإنهاء الحياة، ولا يخفى أن كل إنسان يتمتع، من
حيث المبدأ بحق الحياة على الأقل، وليس من حق أحد أن ينهي حياة أحد، وأن يسلبه حقه
في الحياة، من حيث المبدأ.
بناء على ما تقدم، فقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة، حين قال تعالى: (انه من قتل
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيى
الناس الناس جميعا[16])، لأن الإماتة أولا وبالذات هي بيد الله تعالى، فإنه هو
المالك لنواصي العباد، وهو الذي يحيي ويميت، ليس لأحد أن يشاركه فيه، أو يتدخل في
شأن من شؤونه، ولهذا فإن عاقبة من قتل أحدا عامدا فجزاؤه الخلود في جهنم، قال
تعالى:(ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
عذابا عظيما[17]).
وتتجلى في هذه الآية الشريفة، خصوصية الخلود في جهنم، من جهة أن المقتول إنما قتل
لجهة اتصافه بصفة الإيمان، لأن المفروض أنه لجأ إلى الله تعالى، وحصل على الأمن من
جانبه، فسلبه هذا الحق اعتداء على حدود الله تعالى، وهو نوع من إعلان الحرب عليه،
فالأمر الطبيعي أن يكون جزاؤه العذاب والخلود في جهنم.
إلا أنه ليس كل قتل يعني إعلان الحرب على الله تعالى، بل إن في بعض مفرداته إطاعة
له، من خلال قطع مادة الفساد، وإصلاح شأن الجماعة المسلمة والمجتمع الإنساني على
العموم، وقد بين الإسلام الموارد التي يكون فيها القتل مقبولا عند الله تعالى، بل
مأمورا به، على نحو لو لم يمتثل له، كان نحوا من أنحاء إعلان الحرب، ولذلك قيد قتل
الناس جميعا في الآية المباركة (بغير حق أو فساد في الأرض).
استنادا إلى ما تقدم، يجب أن يكون القائم بتنفيذ القتل عالما بالموارد التي أجاز
الشارع المقدس القتل فيها، فضلا عما يجب فيه، ولا يحق لكل فرد أن يقوم بهذه المهمة،
بدعوى تنفيذ أحكام الله، وإلا عمت الفوضى، وضاعت الحقوق، وانقلبت المصلحة المرجوة
إلى ضدها، لأنه فتح لباب الجريمة والإعتداء على الحقوق، وأهمها حق الحياة كما
ذكرنا.
هذا في حالات القتل العادية، بلا فرق فيها بين الناس، من حيث المبدأ، وتشتد فظاعة
الجريمة، كلما زاد أثرها بالنسبة للشخص، أو الجهة المعرضة للقتل، من الناحية
المعنوية وكلما زادت أهميته، وموقعه الإجتماعي بين الناس وخطورته، لما في ذلك من
أثر على الحياة العامة للناس، ولهذا يختلف تسليط الأضواء عليها بين الناس باختلاف
المقامات، دون أن يعني ذلك زيادة أهمية شخص على آخر من حيث انسانيته.
والإسلام لا يخالف هذه الرؤية الاجتماعية والإنسانية، بل يتبناها ويؤكد عليها،
ولكنه ينظر إليها من منظار مختلف، لأن نظرته إلى الإنسان ومكانته تنطلق من إنسانيته
أولا وبالذات، وليس من موقعه السياسي أو الاجتماعي، وإنسانية الإنسان إنما تتحقق من
خلال التزامه بأحكام الدين، انسجامه مع فطرته التي فطره الله تعالى عليها، فكلما
زاد موقع الشخص في إنسانيته كلما زادت الجريمة بشاعة أيضا، ولهذا كان الخلود في
جهنم مقيدا بقتل المؤمن، من جهة اتصافه بصفة الإيمان، كما تقدم في الآية الشريفة،
حيث أن خصوصية الإيمان والطاعة له تعلى، هي التي تؤهل الإنسان لنيل الكرامة عنده
تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم[18]).
خامسا: قتل الحسين(ع):
لا يوجد في الإسلام، بل في كافة الأديان السماوية، مقام أعلى من مقام
الإمامة، التي تمثل الحافظ لهذا الدين، والعامل على وضع أحكامه وقوانينه موضع
التنفيذ، والحامي لحدوده من تلاعب المتلاعبين وتحريف المحرفين، بعد مقام النبوة
العامة، التي يمثلها النبي الأعظم(ص) ولما كان الإمام الحسينعليه السلام إماما بنص
النبي الأعظم(ص) عندما قال: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) ويحكم كونهما
(سيدا شباب أهل الجنة) بحسب قول الرسول (ص) أيضا، فإن قتله يمثل قتل الدين كله،
ولرسالة النبي(ص)، بل هو قتل للإنسانية جمعاء، ومعنى ذلك أن جميع الآيات القرآنية
الكريمة التي تتحدث عن عقاب المجرمين، وعن قتل المؤمنين، تنطبق عليه عليه السلام
بأحلى صورها، وأصدق معانيها، فهو من قمة هرم الإيمان، فمن قتله كان جزاؤه جهنم
خالدا فيها، وقد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، فقتله ظلم كامل، وهو بغير حق أو فساد
في الأرض، فقتله عليه السلام للناس جميعا.
هذا كله بالإضافة إلى أنه يمثل مقام الإمامة، كما ذكرنا، فقتله قتل للإيمان والدين
وللإنسانية، ولازم ذلك أن يكون قتله دافعا ومحركا، لكل إنسان يمتلك بعضا من العقل،
للثورة على الظلم، وانتصارا للدعوة التي خرج عليه السلام من أجلها.
ولكن هذه الحركة والحرارة لا تؤثر إلا في من يمتلك قلبا واعيا عاقلا، وهم خصوص
المؤمنين، حتى تتحقق العدالة، ويرتفع الظلم من الإنسانية، وهو ما لا يتم إلا على يد
الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه.
وأما غير المؤمنين فإما أن تكون على قلوبهم أقفالها، أو أنهم ليس لهم قلوب أصلا،
ولهذا لا يتحركون، وقد لا يتأثرون بقتله عليه السلام.
وأما قدرتهم على الإبداع، في مختلف ميادين المادة، سواء على المستوى السياسي، أو
الاجتماعي، أو التطور العلمي والتقني، وإن كانت تكشف عن امكانات عقلية، وقدرات
ذهنية، ولكنها لا تتصف بصفة العقل في المفهوم الإسلامي، لأن العقل هو ما يؤدي
بصاحبه إلى احراز الأمان الواقعي، وتحصيل السعادة الحقيقية، بحسب توصيف أمير
المؤمنين عليه السلام، حين سئل عن العقل، فقال: العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به
الجنان.
سماحة الشيخ حاتم إسماعيل
[1] سورة النجم،
آية:3-4
[2] سورة الكهف، آية: 18
[3] سورة النور، آية: 44
[4] سورة آل عمران، آية: 174
[5] معجم مقاييس اللغة، ص828
[6] سورة ق، آية: 37
[7] سورة الشعراء، آية: 88-89
[8] سورة الشعراء، آية: 193-194
[9] سورة الحج، آية: 32
[10] سورة الأعراف، آية: 179
[11] سورة محمد، آية: 24
[12] سورة الصف، آية: 5
[13] سورة الحج، آية: 45.
[14] سورة التوبة، آية:61
[15] سورة الأنعام، آية: 153
[16] سورة المائدة آية:32
[17] سورة النساء، آية:93
[18] سورة الحجرات، آية13